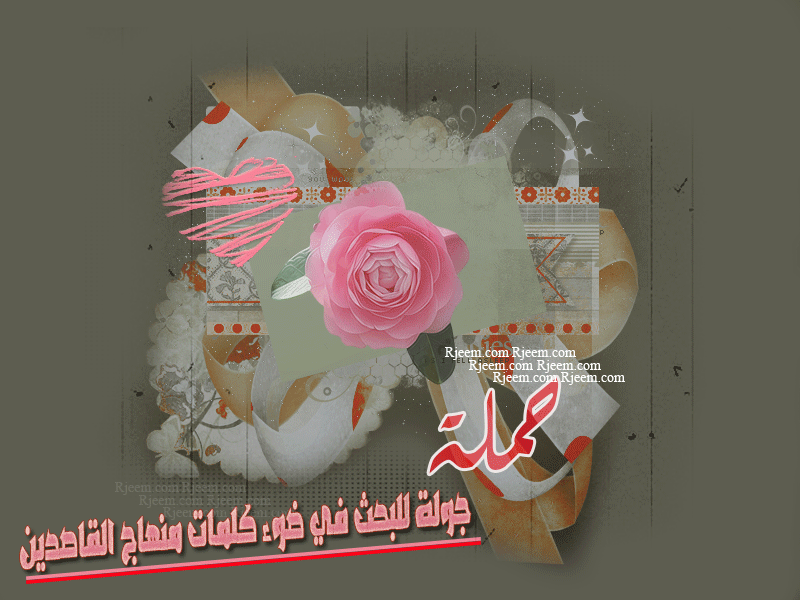باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للعلامة الشيخ بن العثيمين رحمه الله
مجتمع رجيم / المحاضرات المفرغة
سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف- رحمه الله تعالى- في الصبر وثوابه والحثِّ عليه، وبيان محلِّه، ثم شرع رحمه الله في بيان الأحاديث الواردة في ذلك.
فذكر حديث أبي مالك الشعري- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطهور شطر الإيمان)) الحديث، إلى قوله: ((والصبر ضياء)) فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصبر ضياء؛ يعني أن يضيء للإنسان، عندما تحْتَلِكُ الظلمات وتشتدُّ الكُرُبات، فإذا صبر؛ فإن هذا الصبر يكون له ضياء يهديه إلى الحق.
ولهذا ذكر الله- عز وجل- أنه من جملة الأشياء التي يُستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه؛ لأنه كلما سار إلى الله - عز وجل- على طريق الصبر؛ فإن الله تعالى- يزيده هدىً وضياءً في قلبه ويبصره؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الصبر ضياء)).
أما بقية الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ((الطهور شطر الإيمان)).
الطُّهُور: يعني بذلك طهارة الإنسان.
شطر الإيمان: أي نصف الإيمان.
وذلك لأن الإيمان تخْلِيَةٌ وتحْلِيَة.
أي: تبرُّؤٌ من الشرك والفسوق، تبرؤٌ من المشركين والفُسَّاق بحسب ما معهم من الفسق، فهو تخلٍّ.
وهذا هو الطهور ؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسيه ومعنوية من كل ما فيه أذى . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، ((وسبحان الله)) معناها: تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات.
فالله- عز وجل- منزَّه عن كل عيب في أسمائه ، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾[الأعراف:180]، ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو نقص؛ ولهذا قال الله ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ بعد قوله: ﴿لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ [النحل:60 ]، فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه، وله أيضاً الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال الله تعالى:﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾[الدخان:38]، فليس في خلق الله لعبٌ ولهوٌ وإنما هو خلق مبني على الحكمة.
كذلك أحكامه لا تجد فيها عيباً ولا نقصاً كما قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾[التين:8]، وقال عز وجل:﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[المائدة:50] .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ((سبحان الله والحمد لله تملآن- أو قال تملأ- ما بين السموات والأرض)) شك من الرواي: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم : تملآن ما بين السموات والأرض، أو قال تملأ ما بين السموات والأرض.
والمعنى لا يختلف.يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله: ((سبحان الله)) وعلى وصف الله بكلِّ كمال في قوله: ((والحمد لله)).
فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التَّخْليةِ والتَّحْليةِ كما يقولون؛ أي بين نفي كل عيب ونقص، وإثبات كل كمال، فسبحان الله فيها نفي النقائص، والحمد لله فيها إثبات الكمالات.
فالتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به في أسمائه ، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه .
والله - عز وجل- يُحمد على كل حال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يُسرُّ به قال: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) وإذا أصابه سوى ذلك قال ((الحمد لله على كل حال))(107) ثم إن ها هنا كلمة شاعت أخيرا عند كثير من الناس؛ وهي قولهم (( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه)).
هذا الحمد ناقص !!
لأن قولك على مكروه سواه تعبير على قلَّة الصبر ، أو - على الأقل- عدم كمال الصبر، وأنك كارهٌ لهذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يُعبر هذا التعبير، بل الذي ينبغي له أن يعبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعبِّر به؛ فيقول (( الحمد لله على كل حال))، أو يقول : (( الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه)).
أما أن يقول: على مكروه سواه، فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله- عز وجل- وأنه كارهٌ له.
وأنا لا أقول: إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء ، فالإنسان بطبيعته يكره ذلك، لكن لا تُعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله، بل عبِّر كما عبَّر النبي صلى الله عليه وسلم (( الحمد لله على كل حال)).
قوله صلى الله عليه وسلم : ((والصلاة نور)).
فالصلاة نور: نور للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبْره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل.
وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله- عز وجل-، وباب المعرفة في أحكام الله، وأفعاله، وأسمائه، وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، إذا قام العمود قام البناء، وإذا لم يقُم العمود فلا بناء.
كذلك نور في حشرة يوم القيامة؛ كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم : (( أن من حافظ عليه كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحُشِرَ مع فرعون وهامان وقارون وأُبي بن خلف))(108).
فهي نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها، وأن يحرص عليها، وأن يُكثر منها حتى يكثر نوره وعلمه وإيمانه.
وأما الصبر فقال: ((إنه ضياء)) فيه نور؛ لكن نور مع حرارة، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً﴾[يونس: 5].
فالضوء لابد فيه من حرارة، وهكذا الصبر، لابد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب.
فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر، أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة؛ لما في ذلك من التعب القلبيِّ والبدنيِّ في بعض الأحيان.
وقوله: ((الصدق برهان)).
الصدقة: بذل المال تقرُّباً إلى الله- عز وجل- فيبذل المال على هذا الوجه للأهل، والفقراء، والمصالح العامة، كبناء المساجد وغيرها؛ برهاناً على إيمان العبد، وذلك أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس شحيحةٌ به، فإذا بذله الإنسان لله، فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه. فيكون في بذل المال لله- عز وجل- دليل على صدق الإيمان وصحته.
ولهذا تجد أكثر الناس إيماناً بالله- عز وجل- وبإخلافه؛ تجدهم أكثرهم صدقة.
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((والقرآن حجة لك أو عليك)) لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو حجة الله على خلقه، فإما أن يكون لك، وذلك فيما إذا توصَّلتَ به إلى الله، وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه.ففي هذه الحال يكون حجة لك.
أما إن كان الأمر بالعكس، أهنتَ القرآن، وهَجرته لفظاً ومعنى وعملاً، ولم تقُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهداً عليك يوم القيامة.
ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبةً بين هاتين المرتبتين!
يعني: لم يذكر أن القرآن لا لك، ولا عليك ؛ لأنه لابد أن يكون إما لك وإما عليك على كل حال . فنسأل الله أن يجعله لنا جميعاً حجة نهتدي به في الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم.
قوله: ((كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)).
أي: كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل، وهذا شيء مشاهد. فإن الله - تعالى- جعل الليل سكناً وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾[الأنعام:60]، فهذا النوم الذي يكون في الليل هو وفاة صُغرى، تهدأ فيه الأعصاب، ويستريح فيه البدن، ويستجدُّ نشاطه للعمل المقبل، ويستريح من العمل الماضي.
فإذا كان الصباح- وهو الغُدوةُ - سار الناس واتجهوا كلٌّ لعمله.
فمنهم من يتجه إلى الخير، وهم المسلمون، ومنهم من يتجه إلى الشر، وهم الكفار والعياذ بالله.
المسلم أول ما يغدو يتوضأ ويتطهر ((والطهور شطر الإيمان)) كما في هذا الحديث، ثم يذهب فيصلي، فيبدأ يومه بعبادة الله- عز وجل-؛ بالطهارة، والنقاء، والصلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، فيفتتح يومه بهذا العمل الصالح، بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يذكر الله- عز وجل- وأن يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران وهي قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ إلى آخر السورة: 190-200، هذا المسلم. هذا الذي يغدو في الحقيقة وهو بائع نفسه، لكن هل باعها بيعاً يعتقها فيه؟!
نقول: المسلم باعها بيعا يعتقها فيه؛ ولهذا قال: (( فبائع نفسه فمعتقها)) هذا قسم.
((أو موبقها)) معناها: بائع نفسه فموبقها.الكافر يغدو إلى العمل الذي فيه الهلاك؛ لأن معني (أوبقها) أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه بمعصية الله، حتى لو بدأ بالأكل والشرب؛ فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة، ويحاسب عليه.
كل لقمة يرفعها الكافر إلى فمه فإنه يعاقب عليها ، وكل شربة يبتلعها من الماء فإنه يعاقب عليها، وكل لباس يلبسه فإنه يعاقب عليه.
والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [ الأعراف:32] ، للذين آمنوا لا غيرهم.
﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يعني: ليس عليهم من شوائبها شيء يوم القيامة. فمفهوم الآية الكريمة ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾أنها لغير المؤمنين حرام، وأنها ليست خالصة لهم يوم القيامة، وأنهم سيعاقبون عليها.
وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾[المائدة:93] ، فمفهوم الآية الكريمة : أن على غير المؤمنين جناح فيما طعموه.
فالكافر من حين ما يصبح- والعياذ بالله- وهو بائع نفسه فيما يُهلكها، أما المؤمن فبائع نفسه فيما يعتقها وينجيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعاً منهم.
في آخر هذا الحديث بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلي قسمين:
قسم يكون القرآن حجة لهم؛ كما قال : ((والقرآن حجة لك)).
وقسم يعتِقون أنفسَهم بأعمالهم الصالحة.
وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيئة .
والله الموفق.