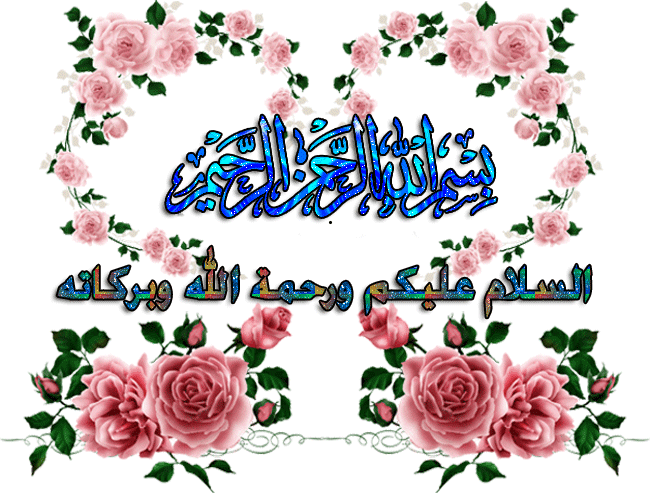شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية
مجتمع رجيم / ليكن رمضان بداية انطلاقتي
فيما يُفطِّر الصَّائم ومَا لا يُفطِّرُه
وهذا نوعان:
منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو: الأكل، والشرب، والجِماع، قال تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]
فأذِن في المباشرة، فَعُقِلَ من ذلك أنَّ المراد: الصيام من المباشرة والأكل والشرب، ولمَّا قال أوَّلاً: {كُتِبَ عليكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]
كان معقولاً عندهم: أنَّ الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ (الصيام) كانوا يعرِفونه قبل الإسلام ويستعْمِلونه [في هذا المعنى] ، كما في الصحيحيْن عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ يوم عاشوراء كان يومًا تصومه قريش في الجاهلية.
الصيام لا شَكَّ أنَّه الإمساك عن المفطرات، لكن لا بدَّ أن يُضاف إلى هذا، التعبُّد لله بالإمساك عن المفطرات حتَّى يكون عبادة، لأنَّ الإمساك عن المفطرات له أسبابٌ متعدِّدة، فإذا كان الغرض من ذلك التعبُّد لله كان صيامًا شرعًا، وكما قال الشيخ - رحمه الله - الأشياء المفطرة بالإجْماع هي هذه الثلاثة: الأكل والشرب الجماع، وما عدا ذلك فإمَّا ثابتٌ لأقيِسة، وإمَّا ثابتٌ لنصٍّ مُختلف في صحَّتِه أو في دلالته، لكن هذه الثلاثة مُجمَع عليها، والصيام كان معروفًا في الجاهلية وفي الشرائع الأخرى، كما قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]
وقالت عائشة - رضي الله عنها - أنَّهم كانوا في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، فلم تأْتِ الشريعة الإسلامية بِجديدٍ إلا في بيان الحكمة من الصَّوم، وهي أنَّه ليس الحكمة من الصوم أن يُمنع الإنسان من فضل الله - عزَّ وجلَّ - من طعامٍ وشرابٍ ونكاح، ولكنَّ الحكمة شيءٌ فوق ذلك، وهو تقوى الله - عزَّ وجلَّ - كما قال تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} حين ذكر فرض الصيام، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلَّم -: ((مَن لَم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل فليْسَ للَّه حاجة في أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه))
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1379
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فالحاجة بِمعنى الإرادة، يعني أنَّه ليس لله إرادةٌ أن يدع الإنسانُ طعامَه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإنَّ قومًا يُمْسِكون عن ملاذِّهم ويتَّقون الله - عزَّ وجلَّ - شهرًا كاملا ويكونون كذلك لابدَّ أن تتغيَّر مناهجُهم، ولِهذا كان شهر الصيام لِمَن وفِّق تربيةً عظيمةً للنَّفس، بالصبر والتَّحمل والتَّقوى وكثرة الطاعات، نسأل الله أن يَجعلنا وإيَّاكم مِمَّنِ اتَّعظ به وانتفع.
وفي قوله عزَّ وجلَّ: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187] الإشارةُ إلى معنى نفيسٍ، وهو أن لا يُريد الإنسانُ بالجِماع مُجرَّد نيل الشَّهوة، بل ابتغاء ما كتب الله لنا، يَعني من الذُّرِّيَّة، وهو إذا نوى هذا حصَل هذا وهذا، يعني لا يفوتُه إذا نوى ابتغاء ما كتبَ اللهُ له أن يكون له ذُرِّيَّة، بل يَحصل على هذا وعلى هذا، ولهذا قال بعضُ المفسِّرين على قوله: {وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ} أي بطلب الولد.
[وقد ثبت عن غير واحد]: أنَّه قبل أن يُفرض شهر رمضان أمرَ بصومِ يوم عاشوراء، وأرسل مناديًا ينادي بصومه؛ فَعُلِمَ أنَّ مُسمَّى هذا الاسم كان معروفًا عندهم.
وكذلك ثبت [بالسنة] واتِّفاق المسلمين: أنَّ دَمَ الحَيْضِ يُنافي الصوم، فلا تصوم الحائض، لكن تقضي الصيام.
وثبت [بالسنة] - أيضًا - من حديث لَقِيط بن صَبرة، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((وبالِغْ في الاستِنْشاقِ إلا أن تكون صائمًا))
الراوي: لقيط بن صبرة المحدث:الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 386
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
فدلَّ على أنَّ إنزالَ الماء من الأنف يُفطر الصائم، وهو قول جماهير العُلماء.
ومن هنا صار في المسألة خلاف، يعني إذا أكل الإنسانُ الشَّرابَ من غير الفم ففيه خلافٌ بين العلماء، ولكن ما دلَّ عليه الحديث يَجب أن يكون معتبرًا، وهو أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إلا أن تكونَ صائمًا))، ولا نعلم فائدةً لهذا الاستِثْناء إلا خوفَ أن ينزل الماءُ من الأنف إلى المعدة، وإلا لم يَكُنْ للاستثناء فائدة، فالصَّواب ما دلَّ عليه الحديث، لكنْ لو جاء مُجادل وقال: المسألة ليست إجماعًا وأنا لا أعتبر إلا ما ثبتَ بالنَّصِّ والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياسًا، قلنا له: الحمد لله، هذا ثابتٌ بالنَّصِّ لأنَّنا لا نعلم فائدة لاستثناء الصائم إلا خوفَ أن ينزل الماء من أنفِه إلى معدته فيفطر.
وفي السنن حديثان: أحدُهما: حديث هشام بن حسان، عن مُحمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ذَرَعَهُ قَيءٌ وهو صائم فليس عليه قَضَاءٌ، وإنِ استقاء فليقْضِ))
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2380
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وهذا الحديثُ لم يثبُتْ عند طائفةٍ من أهل العلم؛ بل قالوا: هو من قوْلِ أبِي هُريرة، قال أبو داود: سَمِعْت أحمدَ بن حنبل قال: "ليس من ذا شيء". قال الخطَّابي: "يريد أنَّ الحديث غير محفوظ".
وقال التِّرْمذي: سألتُ مُحمَّد بن إسماعيل البخاريَّ عنه، فلم يعرِفْه إلا عن عيسى بن يونس، قال: "وما أراه محفوظًا".
قال: وروى يَحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم أنَّ أبا هُريرة كان لا يرى القَيْءَ يفطر الصائم.
المؤلِّف سيُبيِّن ثبوتَ هذا الحديث أو عدمَ ثبوته، لكن قوله: ((ومن استقاء فليقض)) فيه فائدة؛ وهي أنَّ الإنسان إذا أفطر متعمِّدًا فعليْهِ القضاءُ، خلافًا لِما اختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحِمه الله - حيث قال أنَّ من تعمَّد الإفطار فلا يقضِ، والصواب أنَّه يقضي، بِخلاف الذي لم يصم اليوم من أوَّله فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر؛ لأنَّ الأوَّل شرع في العبادة فلَزِمَتْه بشروعه فيها، والتزمها في أوَّل نهاره، والثَّاني لم يلتزِمْها إطلاقًا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلاً ليس عليه أمْرُ الله ورسولُه، وقد تعدَّى حدود الله، فقد حدَّ الله الصَّومَ بشهرٍ مُعَيَّن في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقُمْ بالصَّوم في هذا فقد تعدَّى حدود الله، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]
والله لا يقبل من ظالم، فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة:
- قول الجمهور؛ أنَّه يقضي سواءٌ صام ثُمَّ أفطر عمدًا أم أنَّه ترك الصيام من أوَّله.
- الثاني: أنَّه لا يقضي سواء تَركَ الصِّيام من أوَّله أم تعمَّد الإفطار.
الثالث: التَّفصيل أنَّه إن ترك الصيام ثُمَّ صامه بعد رمضان فإنَّه لا يقضيه؛ لأنَّه لن ينتفع به، وأمَّا إذا صام ثُمَّ أفطر عمدًا وجَبَ عليْهِ القضاء، وهذا هو الرَّاجح، وقد رأيتُم الحديث الآنَ حديثَ أبي هُريرة: ((ومنِ استَقاءَ فليقْضِ))، يعني مَنِ استقاء عمدًا فليقض.
وهُنا مسألة: لو أنَّ إنسانًا أحسَّ بالقَيْءِ هل يجب عليه أن يَمْنَعَه؟ الجواب لا يجب، كما لو فكَّر وأحسَّ بانتقال المنيِّ، فإنَّه لا يلزمه أن يَحجزه؛ لما في ذلك من الضرر ولأنَّه لم يتعمَّد.
مسألة أخرى: لو أنَّه أحسَّ بِهيجان المعدة ثُمَّ استقاء أيفْطِر أم لا؟ يفطِر لأنَّه تعمد القيء، والمعدة قد تهيج أحيانًا ويتهيَّأ الإنسان للقيء ولكن تسكُنُ ولا يحصل شيء.
قال الخطَّابي: وذكر أبو داود أنَّ حفص بن غياث رواه عن هشام، كما رواه عيسى بن يونس، قال: ولا أعلَمُ خلافًا بين أهل العلم في أنَّ مَن ذرعَه القَيْءُ فإنَّه لا قضاء عليه، ولا في أنَّ مَن استقاء عامدًا فعليه القضاء، ولكنِ اختلفوا في الكفَّارة، فقال عامَّة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاءُ والكفَّارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.
قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتيْنِ عن أحمد في إيجابه الكفَّارةَ على المحتجِم، فإنَّه إذا أوجبها على المحتجِم فعلى المستقيء أولى، لكنَّ ظاهر مذهَبِه: أنَّ الكفَّارة لا تَجِبُ بغَيْرِ الجِماع؛ كقول الشَّافعي.
وهذا هو الصحيح أنَّه لا كفَّارة إلا بالجماع، وذلك أنَّ الأصل براءة الذمة، ولا يُمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليلٍ من الكتاب والسنة أو الإجماع، لأنَّنا مسؤولون عن إيجاب ما لم يَجب كما أنَّنا مسؤولون عن تَحريم ما لم يحرم، فالصَّواب أنَّ الإنسان إذا تعمَّد الفطر في رمضان - يعني صام ثُمَّ أفطرَ عامِدًا - أنَّه آثِمٌ ويلزمه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء، وأمَّا الكفَّارة فلا تَجب إلا بالجِماع.
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجهٍ يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علَّته، [وهي] انفِراد عيسى بن يونس، وقد [ثبت] أنَّه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديثُ الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن، كالتِّرمذي، عن أبي الدرداء: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، فذكرتُ ذلك لثوبان، فقال: صدق، أنا صببتُ له وضوءًا، لكن لفظ أحمد: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضَّأ"؛ رواه أحمد عن حسين المعلم.
قال الأثرم: قلت لأحمد: قدِ اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يُجوده. وقال الترمذي: حديث حسين [أصح] شيء في هذا الباب، وهذا قد استُدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدلُّ على ذلك، فإنَّه إذا أراد بالوضوء الوضوءَ الشرعي، فليس فيه إلا أنَّه توضَّأ، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب، بل يدلُّ على أنَّ الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل: إنَّه مستحبٌّ كان فيه عمل بِالحديث.
قوله: إذا أراد الوضوء: الوضوء الشرعي أفادنا أنَّ هناك وضوءًا ليس شرعيا، وهو الوضوء اللغوي، وهو النظافة، ولكن لدينا قاعدة مهمَّة وهي: أنَّ ألفاظ الشرع تُحمل على الحقائقِ الشَّرعيَّة، والحقيقة الشَّرعيَّة للوضوء: أنَّه التَّطهُّر المعروف، ولكن يَمنع من القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكرَهُ الشَّيخ - رحمه الله - أنَّ هذا فعلٌ مُجرَّد، والفعل المجرَّد لا يدلُّ على الوجوب.
وكذلك ما رُوِيَ عن بعض الصحابة من الوضوء من الدَّم الخارج، ليس في شيء منه دليلٌ على الوجوب، بل يدلُّ على الاستحباب، وليس في الأدلَّة الشرعيَّة ما يدلُّ على وجوب ذلك، كما قد بُسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره، عن حميد، عن أنس قال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتوضَّأ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحاجِمِه، ورواه ابن الجوزي في (حجَّة المخالف) ولم يضعِّفه، وعادته الجرح بِما يمكن.
وأمَّا الحديث الذي يروى: ((ثلاث لا تفطر: القيء، والحجامة، والاحتلام))، وفي لفظ: ((لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم))، فهذا إسناده الثابت: ما رواه الثوري وغيره، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هكذا رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن عبدالرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال.
قلت: روايته عن زيد من وجهين مرفوعًا لا يُخالف روايتَه المرسلة بل يقوِّيها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: "إذا ذرعه القيء".
[ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً، وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته؛ لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه بالاحتلام، ومنِ احتلم بغير اختياره - كالنائم - لم يفطر باتفاق الناس].
وأما حديث الحجامة: فإمَّا أن يكون منسوخًا، وإما أن يكون ناسخًا لحديث ابن عباس: أنه احتجم وهو محرم صائم أيضًا، ولعل فيه القيء إن كان متناولاً للاستِقاءة هو - أيضًا - منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصَّان ناقل وباق على الاستصحاب، فالنَّاقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه.
وأمَّا منِ استمنى فأنزل: فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه.
وقد ظنَّ طائفة أن القياس [ألا] يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس.
ولهذا عندهم قاعدة يقولون: لا وضوء مما دخل بل مما خرج، ولا فطر مما خرج بل مما دخل، لكن مَن قال هذه القاعدة!!
وقد بسطْنا في الأصول: أنَّه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.
فإن قيل: فقد ذكرتم أنَّ مَن أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوَّت صلاة النَّهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويتُه لها من الكبائر، وأنَّها ما بقيتْ تقبل منه على أظهر قولَيِ العُلماء، كمن فوَّت الجمعة، ورمْيَ الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء.
وقد روي في حديث المجامع في رمضان: أنَّه أمره بالقضاء.
قيل: هذا إنَّما أمره بالقضاء؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يتقيَّأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو يتقيَّأ لأنَّه أكل ما فيه شبهة كما تقيَّأ أبو بكر من كسب المتكهِّن.
قول الشيخ - رحمه الله - فيه نظر، وحصره التقيؤ بكوْنِه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر، قد يتقيَّأ الإنسان لثقل بطنه أو للتداوي بالاستسقاء بدون ضرورة، لكن ما قلنا أقرب للأصول، أنَّه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء، لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له، ولهذا سمَّى الله تعالى مناسك الحج نذورًا ومدح الذين يوفون بنذورهم، وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف كما توهَّمه بعض الناس، بل إن قوله {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} يعني العبادات الواجبة وكذلك قوله {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} المراد المناسك.
وإذا كان المتقيِّئ معذورًا كان ما فعله جائزًا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر
الآن الشيخ - رحمه الله - سوف يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيَّأ عمدًا بأنَّه إنَّما يتقيَّأُ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - مع أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - لا نعلم أنه كان صائمًا صومًا واجبًا، لكن فيما يظهر أنه استمرَّ في صومه، أو أفطر لا ندري الله أعلم.
ثم أتى بحديث آخر أنَّ الرَّسول أمر المجُامع أن يقضي فأجاب عنه.
وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعَّفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أَمَرَهُ بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدًا للفطر لم يكن ناسيًا ولا جاهلاً.
أمَّا كونُه أنه لم يكن ناسيًا ولا جاهلاً فظاهرٌ من قوله: "هلكت" فإنَّ هذا يدلُّ على أنَّه ليس بجاهل ولا ناس، وأمَّا كونُه لَم يأمُرْه بالقضاء فقد تعقَّبه الشيخ الألباني، وقال: فيه نظر؛ فقد ذكره أكثر من واحد وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه، ثم قال: ورواه البيهقي من طريق أبي مروان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اقضِ يومًا مكانه))، قال البيهقي: وكذلك روي .... ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في "الفتح" ثم قال: وبِمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً (يقوله الحافظ).
والمُجامِع النَّاسي فيه ثلاثةُ أقوال في مذهب أحمد وغيْرِه، ويذكر ثلاث روايات عنه:
إحداها: لا قضاءَ عليه ولا كفَّارة، وهو قول الشَّافعي وأبي حنيفةَ والأكثرين.
والثانية: عليه القضاء بلا كفَّارة، وهو قول مالك.
والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد.
والأوَّل أظهر - كما قد بُسِطَ في موضعِه - فإنَّه قد ثبت بدلالة الكتاب والسُّنَّة: أنَّ مَن فعل مَحظورًا مخطئًا أو ناسيًا لم يؤاخِذْهُ الله بذلك، وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم.
هذا هو الفقه العظيم، إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعله، فما دام هو معفوًّا عنه فكأنه لم يفعله، وإذا لم يفعله هل يجب قضاء أو كفارة؟ لا يَجب لا قضاء ولا كفارة، وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، في الصلاة إذا تكلم جاهلاً أو ناسيًا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم، في الصيام إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يؤاخذ فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب، في الحج إذا فعل محظورًا ناسيًا أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ فهو بمنزلة من لم يفعله، وهذا الفقه من شيخ الإسلام - رحِمه الله - عظيم، يعني ما كان يناله أحدٌ من الذين يتبعون المذاهب، اللهم إلا نادرا، كلُّ ما لم تؤاخَذْ عليه فكأنَّه معدوم إلا في شيء واحد، فإذا تركت مأمورًا فالعبادة ناقصة ما أتيت بها، لابد أن تأتي بها على ما أمرت، ولهذا لم يعذر النَّبيُّ الرجلَ الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له: ((ارجع فصل فإنَّك لم تصل))؛ لأنه ترك واجبًا، لكن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات لأنَّه لم تبلغه الشريعة، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم.
ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتكبًا لِمَا نُهي عنه، وحينئذٍ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنَّما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه.
وطرد هذا: أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيًا ولا مُخطئًا لا الجماعِ ولا غيره، وهو أظهرُ قولي الشافعي.
وأمَّا الكفارة والفدية، فتلك وجبت لأنها بدل المتلَف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ، فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خَطَأً بنص القرآن وإجماع المسلمين.
القرآن نصَّ نصًّا صريحًا بوجوب الكفَّارة في قتل الخطأ، وكلامُه هنا يظهر منه أنَّه يرى وجوب الجزاء في قتل الصَّيد على الجاهل والناسي، والرَّاجح أنَّه لا يَجِبُ في قتل الصيد خطأً أو نسيانًا جزاء، وهو نصُّ القرآن، قال الله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]
مُّتَعَمِّدًا: مشتقّ، وهو وصفٌ مناسبٌ للحكم، فوجب أن يَختلف الحكم بفَقْدِه، وأنَّه إذا قتله غَيْرُ المتعمِّد فليس عليه جزاء، وهذا هو الصَّواب، وهو أيضًا مُقتضى طرد القاعدة أنَّ جميعَ المحظورات إذا كان جاهلاً أو ناسيًا ليس فيها شيء، ولا يصحُّ قياسُ هذا على إتلاف الصبيِّ لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والنَّاسي لأموال بني آدم؛ لأنَّ الصيد في الإحرام إنَّما حَرُم لحقِّ الله لا لأنه ملك فلان أو فلان، وعلى هذا فإذا قتل المُحرِم صيدًا - ناسيًا أو جاهلاً - وهو مَملوك لفلان ماذا عليه؟ عليه الضمان إما مثله إن أمكن أو قيمته.
وأمَّا سائر المحظورات، فليستْ من هذا الباب، [وتقليم] الأظفار وقصُّ الشارب والترفُّهُ المنافي للتفث كالطيب واللباس؛ [ولهذا] كانت فديتها من جنس فديةِ المَحظورات ليستْ بِمنزلة الصيد المضمون بالبدل.
خلافًا للمذهب في هذه المسألة أنَّ تقليم الأظفار وقصَّ الشارب كالصيد لا يَسقط بالنسيان والجهل، والصواب خلاف ذلك، فالصَّواب أنَّها ليست من باب المتلفات، فأيُّ قيمة للظفر إذا قصَّه الإنسان أو الشعر؟ ليس هناك قيمة.
فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورًا: ألا يضمن من ذلك إلا الصيد.
وللناس فيه أقوال: هذا أحدُها، وهو قول أهل الظاهر.
والثاني: يضمن الجميع مع النسيان، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه.
والثالث: يفرَّق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطِّيب واللباس، وهذا قول الشَّافعي وأحمدَ في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجودُ من غيْرِه، لكنَّ إزالة الشعر والظفر ملحقٌ بِاللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.
والرابع: [أن] قتل الصيد خطأٌ لا يضمنه، وهو رواية عن أحْمَد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأوْلى.
وجدت أنَّ شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النِّسيان أو الجهل أو الكراهة، لكن ذكر في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد، وقال في الفروع اختاره أبو محمد الجوزي وغيره، فكأنَّ شيخ الإسلام يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام، أنَّه تجب الفدية.
وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو مخطئًا، فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ كمالك، وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي، ومنهم من قال: لا يفطر الناسي ويفطر المُخْطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفةَ جعل النَّاسي موضع استحسان، وأمَّا أصحاب الشافعي وأحمدَ فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنَّه لا يُمكِن الاحتِراز منه، بخلاف الخطأ، فإنَّه يُمْكِنه ألا يفطر حتى يتيقَّن غروب الشمس، وأن يُمسك إذا شكَّ في طلوع الفجر.
وهذا التَّفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإنَّ السُّنَّة للصائم أن يعجِّل الفطر ويؤخِّر السحور، ومع الغيم المطبق لا يُمْكِن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدًّا يفوت [مع] المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب [على] ظنه غروب الشمس [و] أُمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربَّما يؤخِّرها حتَّى يغيب الشفَق وهو لا يستيقن غروب الشمس، وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنهم كانوا يستحبُّون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علَّل ذلك بعض أصحابه [بالاحتِياط] لدخول الوقت، وليس كذلك؛ فإنَّ هذا خلافُ الاحتِياط في وقت العصر والعشاء، وإنَّما سنَّ ذلك؛ لأنَّ هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخّرت الأولى من صلاتي الجمع، وقدمت الثانية لمصلحتين:
إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلُّوها مرَّة واحدة لأجل خوف المطر، كالجمع بينهما مع المطر.
والثانية: أن يتيقَّن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، [و] يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد.
الثاني: أنَّ الخطأ في تقديم العصر والعشاء أوْلى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإنَّ فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحالٍ بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛ لأنَّ ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشَّكِّ.
وهذا فيه ما [ذكره] أصحاب المأخذ الأوَّل من الاحتِياط، لكنَّه احتياط مع تيقُّن الصلاة في الوقت المشترَك، ألا ترى أنَّ الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت [لطرد] هذا في الفجر، ثم يطرد في العصر والعشاء.
فإن قيل: فإذا كان يستحِب أن يؤخِّر المغرب مع الغيم، فكذلك يؤخر الفطور.
قيل: إنَّما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث [يصلِّيهِما] قبل مغيب الشفق، فأمَّا تأخيرها إلى أن يَخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.
ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، [و] لا يستحب أن يؤخِّر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل [في] هذا حرجٌ عظيم على الناس، وإنَّما شرع الجمع لئلا يُحرَج المسلمون.
وأيضًا، فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلَهُما مقترِنَتَيْن؛ بل أن يؤخِّر الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلُّون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى [ذهاب] إلى البيوت ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصحِّ القولين، كما [قد] ذكرناه في غير هذا الموضع.
الموالاة والترتيب في الجمع، يجب أن نعرِّفهما، فالترتيب معناه أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، والموالاة ألا يفصل بينَهُما بفاصل كثير، فشيخ الإسلام - رحمه الله - يرى أنَّ الجمع معناه ضمُّ أحَدِ الوقْتَيْنِ إلى الآخر، وأنَّه لا تشتَرَطُ الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع تقديمًا وأمَّا التَّقديم فلا، والاحتياط أن يوالي بيْنَهُما لا في التأخير ولا في التقديم، لكن كون ذلك شرطًا في جَمع التقديم فيه شيء من القلق ولا يطمئنُّ إليه الإنسان كثيرًا، لكن الاحتياط يضم إحداهُما إلى الأخرى، وأن لا يفصل بينَهُما، أمَّا التَّرتيبُ فلا بد منه أن يبدأ بالأولى قبل الثانية.
وأيضًا، فقد ثبت في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طلعت الشمس".
وهذا يدل على شيئين: [على] أنَّه لا يستحبُّ مع الغيم التأخيرُ إلى أن يتيقَّن الغروب؛ فإنَّهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرْهُم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة مع نبيِّهم أعلم وأطوع لله ولرسوله مِمَّن جاء بعدهم.
والثاني: [أنه] لا يَجِبُ القضاء؛ فإن النَّبيَ - صلى الله عليه وسلم - لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك [كما] [نقل] فطرهم، فلمَّا لم ينقل ذلك دلَّ على أنَّه لم [يأمرهم] به.
وعلى هذا فإذا كان يوم غيم لا نقول للناس: انتظروا حتى تتيقَّنوا الغروب؛ لأنَّه لو كان الانتِظار حتَّى يُتيقَّن الغروب واجبًا لتأخَّر الصحابة حتى يتيقَّنوا الغروب، وهذا قد يكون أمرًا يستدعي وقتًا طويلاً خصوصًا مع كثافة الغَيْم، فإنَّه قد لا يتفرَّق إلا بعد مدَّة طويلة، فيفوت تعجيل الفِطْر الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلَّم -: ((لا يزال النَّاس بخير ما عجّلوا الفطر))، هذا إذا لم يكن مع الإنسان ساعاتٌ، أمّا الآنَ - والحمد لله - وقد جاءت الساعات فالانتِظار إن قلنا به مع الغيم لن يعدُوَ أن يكون دقيقتَيْنِ أو ثلاثًا، يعني لا يتأخّر كثيرًا، لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس هناك ساعات تحدد الوقت.
أمَّا الشيء الثاني فهو أنَّه لا يَجِبُ القَضاء وهذا هو المهم، فلا يَجب القضاء بناءً على القاعدة وهي: العذْرُ بالجهل والنِّسيان والإكراه، والإنسانُ مأمورٌ بأن يفطر ويعجل الفطر، فإذا فعل ما أُمِر به ثُمَّ تبيَّن الأمر بِخلاف ذلك فإنَّه لا يُلزَم بالقضاء، وكيف يُلزَم بالقضاء مَن أطاعَ الله ورسولَه.
فإن قيل: فقد قيل لِهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أوبُد من القضاء؟
قيل: هشام قال ذلك برأيه، و[لم] يروِ ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده [بذلك] علم: أنَّ مَعمرًا روى عنه قال: سَمِعْت هشامًا قال: "لا أدري أقضَوْا أم لا؟" ذكر هذا وهذا عنه البخاري.
ومعلوم حتَّى العبارة الأولى لا تدلُّ على أنَّه رفع الحديث بل على أنَّه قاله تفقُّها لقول "أوبدٌّ من قضاء" يعني كأنه يقول لا بد من القضاء، وهذا قاله تفقُّهًا من عنده - رحِمه الله - لكن اللفظ الثاني "لا أدري أقضوا أم لا؟" واضح، يعني أوضح من الأوَّل مع أنَّ الأوَّل عند التأمُّل يدل على أنه قاله تفقُّهًا من عنده.
والحديث رواه عن [أمه] فاطمة بنت المنذر عن أسماء.
وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه [ ] - [وهو] قرين أحمد بن حنبل - ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه، وقولهما كثيرًا ما يجمع بينه.
إذا يكون أبو هشام وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين قال إنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعلى هذا يكون المعتمد عدم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم النبيُّ به بلا شَكٍّ، إذ لا يُمْكِن أن يؤخّر البلاغ مع حاجة الناس إليه، ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله، ولابد أن تبقى إلى أن يأذن الله - تعالى - بفناء أهل الأرض، فكلَّما تأملت الحديث وجدتَ أنَّ كالمتيقن أنَّهم لم يقضوا.
والكَوْسَج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما؛ ولِهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنَّه روى قولَهما من مسائل الكوسج.
وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمَّة [السلف] والسنة والحديث، [و] كانوا يتفقَّهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولَهما على أقوال غيرهما، وأئمَّة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم [هم] - أيضًا- من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق.
وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أُسْأَلُ عن إسحاق؟ إسحاق يُسأَل عنِّي.
تواضعٌ عظيمٌ الله أكبر، فمن عرف قدر غيره، عرف غيره قدره، الله المستعان.
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثَور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث - رضي الله عنهم أجمعين -.
وأيضًا، فإن الله قال في كتابه: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ} [البقرة: 187]، وهذه الآية مع الأحاديث الثَّابتة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُبيِّن أنَّه مأمورٌ بالأكْل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشَّكِّ في طلوعه مأمور بالأكل - كما قد بسط في موضعه -.
وعند المتعمِّقين يقولون إذا شككْتَ في الفجر وجب عليك الإمساك، ولهذا عندهم مدفعُ إمساك ومدفع فجر، وهذا لا شك أنه من التعمُّق المذموم؛ لأنَّ الرب - عزَّ وجلَّ - هو الذي يتعبد عباده وقد قال: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}، ولم يقل حتَّى يطلع بل قال حتى "يَتَبَيَّنَ"، فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكًّا في طلوع الفجر حتَّى يتبين لك، فإذا تبين أمسِك.
وهنا مسألة: لو أنَّه تَبيَّن للإنسان الفجر وهو يُجامع زوجته ماذا يفعل؟ الفقهاء قالوا إن بقي فعليه الكفَّارة، وإن نزع فعليه الكفَّارة، لأنَّ النَّزع جماع عندهم، فماذا يصنع؟ نقولُ: ينزع فورًا ولا شيءَ عليه، لأنَّ هذا عمل للتخلُّص من الإثْم، فرق بين الإنسان الذي يتخلَّص من الإثم والذي يريد الوقوع في الإثم.
نظير ذلك: لو أنَّ المُحْرِم أصابه طِيبٌ في ثوبِه أو في بدنِه فإنَّ مسَّ المحرم للطيب مُحرَّم، لكن لو أراد أن يَغْسِله هل نقول له: حرام عليك أن تغسله؟ لا، لأنَّ ذا للتخلص منه.
ونظير ذلك أيضًا: الرجل يستنجي بالماء، ويُباشِر النَّجاسة البول أو الغائط بيده، ومُباشرة النَّجاسة منهيٌّ عنها، هل نقول لا تفعل؟ لا، نقول: افعل لأنَّك تُريد التَّخلُّص.
ونظير ذلك: الرجُل يغْصَب أرضًا ثُمَّ يَمُنُّ الله عليه وهو فيها ويَجمع متاعه وما يتعلَّق به ليخرُج منها، هل نقول إنَّه آثم؟
لا، نقول هذا للتخلص.
فيجب التنبُّه لهذه الفائدة، وهو أنَّ مَن باشر المُحرَّم للتخلُّص منه فإنَّ ذلك أمر واجبٌ عليه، ولا يدخُل في الحرام.
فهِمْنا من كلام الشيخ - رحمه الله - أنَّ الإنسان يأكُل ويشرب حتَّى مع الشَّكِّ بطلوع الفجر، وأنَّه لا إثْمَ عليه، وأنَّ هذا مُقْتضى قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} [البقرة: 187]، وأنه متى غلب على ظنِّه أنَّ الشمس غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصَّحابة - رضي الله عنهم - في عهد نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم - لكن مع الشَّكِّ في غروب الشمس لا يَجوز الفِطْر بِخلاف الشك بطلوع الفجر، والفرق ظاهرٌ؛ لأنَّ الشَّكَّ في طلوع الفجر يعارضُه أن الأصل بقاء الليل، والشكَّ في غروب الشَّمس يعارضُه أنَّ الأصل بقاءُ النَّهار، لكن مع غلبةِ الظَّنِّ يعمل بغلبة ظنِّه ويأكل ويشرب، فإن تبيَّن له بعدُ أنَّ الشَّمس لم تغرب أمسك وصحَّ صومُه.